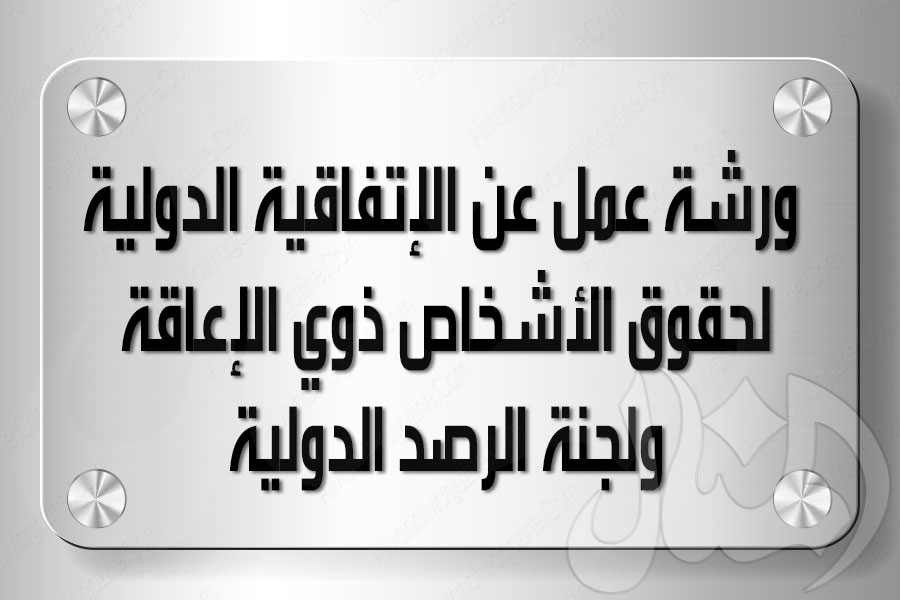الشرقيون عادة، يخافون من الحسد كما القتل وعلى الأرجح، من أنفسهم يخافون!!
لا أستطيع أن أقول أو أجزم بأن مرحلة ما قبل الخامس الإعدادي كانت ناضجة أو مثمرة، لكن البداية الحقيقة تعتبر بعد ذلك الوقت من حياة الدراسة العلمية التي اخترتها دون تفكير أو رغبة، خاصة بعد أن استبدلت المواد الأدبية بالعلمية لأن أصحابي ذهبوا إلى مجال العلم ولم يبق لي من صديق يعزيني في تخصص الأدب…
هكذا كان قرار توجهي العلمي ساذجا وطفوليا، كأنني سأذهب مع أصحابي الذين فضلتهم عن جهل إلى سفرة أو رحلة… لأجد نفسي فيما بعد إنسانا يقدس الأدب ويتخذه مذهباً له وفي ذات الوقت لا يكترث بالعلم، خاصة الزراعي منه!!
قلت أن المرحلة الإعدادية العلمية الخامسة كانت نقطة التحول في حياتي الكتابية… ذلك عندما رأيت نتيجة امتحاني في نصف السنة لتلك المرحلة الدراسية بمادة اللغة العربية مائة من مائة… استغربت كما زملائي في الفصل، وكان جواب الأستاذ لحظتها:
أنا أعلم أن ليس بإمكان هيثم أن يحصل على هذه الدرجة في اللغة العربية، لكنني ومع ذلك ما أن قرأت تعبيره، خياله، أفكاره، وقوة حبكته في موضوع الإنشاء، ورأيت اسمه على دفتر الامتحان حتى أغلقته وأعطيته الدرجة الكاملة تقديراً وإعجاباً مني لقدرته وتصرفه الجميل الرائع بمفردات اللغة، والطريقة التي بها روضها، وعرضها حتى ظهر الموضوع وكأنه قصة قصيرة… ثم أردف بانبهار مأخوذ بعد أن أخذ نفساً طويلاً: بل أكاد أجزم أنه كان قصة قصيرة متكاملة الأركان!!
عندها شعرت بزهو واعتداد وثقة بنفسي لأعيد الكرة مرة أخرى وبقصة جديدة – بموضوع جديد – كاد يكون أفضل من أخيه، وهكذا بدأت أكتب ما يخطر في بالي من أفكار ومواقف حدثت لي أو لأهلي أو لأصدقائي لأصقلها بقصة ذات حبكة ساخرة، لذيذة ومشوقة وكأن اللعبة قد أعجبتني… لأجد نفسي فيما بعد الطالب الذي يكتب للطلاب مواد الإنشاء والخطابة عن غير قصد أو غرور أو حتى تكلف…
في هذا الوقت لم تتغير مناهج قراءاتي في عالم الأدب… بقيت على حالها، مبعثرة وغير مبرمجة؛ أقرأ كل ما يصادفني أو أجده أمامي حتى وإن كانت معلوماتي وقتها غير كافية ولا حتى قدرتي الإدراكية تستطيع استيعابها ككتاب العقب الحديدية لجاك لندن أو الله والإنسان لحنا الفاخوري أو الكتب التي لم أعِ حينها بأنها لا تتناسب وعمري الصغير ككتاب ضياع في سوهو لكولن ولسن!! والسبب يعود بالتأكيد هو غياب السيطرة أو التوجيه من قبل العائلة البسيطة في هذا المجال؛ وبقيت أقرأ هكذا بشغف وجنون دون إدراك خطر القراءة غير الموجهة والتي قد تؤدي إلى مشاكل نفسية وفكرية لا تحمد عقباها…
لكنني تجاوزت تلك المرحلة ولم أصب إلا بعفريت الحيادية الذي جعلني لا أحب أن أتخذ نظرية أو مبدأ أو قانوناً في اتجاهاً واحد… وآمنت بالوسط وخضعت لسلطانه، وكأني عبد له، وقلت لنفسي جاداً مستسلماً لتلك الهواجس التي وشمت في عقلي:
إن الكون له أربعة اتجاهات ولا يمكن أن أتحدد في اتجاه واحد… وهكذا كنت وترعرعت… لأكون في نظر نفسي كاتباً فيما بعد لكل الاتجاهات، وأقصد بالتأكيد هنا الاجتماعية داخل المجتمع، وهل يخلو مجتمع من هذا التنوع؟! أبداً، فالتنوع هو الثقافة، هو الاختلاف والرأي الآخر وهو طبيعة الإنسان والأشياء.
لذلك كتبت للطفل والتاجر والفنان والسكير والدجال والنبي والملاك… ومع ذلك هناك الكثير مما لم أكتب له بعد…
درست الموسيقا في معهد خاص، ليسَ لصاحب المعهد من هم سوى الدينار! فخرجت منه بعد مضي أكثر من سنة وأنا لا أعزف إلا على الجيتار وبمبادئ لا تتناسب والمال المدفوع!!
مضيت في عالم الأدب وأنا أنظر إلى الفنون التشكيلية نظرة حالم لا يستطيع أن يمسك بزمام الواقع… لأنه يحلم! فالمرض الحيادي جعلني استقل في أفكاري حتى الحزبية منها… فلم أنتم إلى أي حزب، حتى يومي هذا…
هذا كان السبب الرئيسي من عدم قبولي في أكاديمية الفنون الجميلة رغم حصولي على معدل يجعلني أدرس الهندسة بدل الفن!! ومعَ ذلك جاء الرفض صريحاً وقحاً ومتماديا… وقررت بعدها أن أدرس أي شيء كي أتجنب الحرب التي كانت نارها مستعرة بين العراق وإيران…
وشاءت الصدف أن أدخل الزراعة التي لي فيها مواقف وحكايات نادرة، لو سجلتها على الورق، لخرجت منها بكتاب لذيذ، مشوق ونادر.
ففي إحدى المرات التي سئلت فيها من قبل أستاذي بمادة البستنة الزراعية بقوله: عدد لي خمسة أنواع من أسرة الحمضيات؟!
وكانت النتيجة مؤلمة وخائبة كما توقعت ولم أصدم فيها!! قلت بإيجاز وحذر شديدين: البرتقال، الليمون والنارنج… ثم قررت الصمت لجهلي المطبق بالأنواع الأخرى، ولولا شيوع هذه الأنواع الثلاثة في أسواق الفاكهة والخضار… لما كنت قد عرفت!! وقلت في سري متألماً:
ماذا سيحصل لو سألني عن خمس من روايات أناتول فرانس أو خمس من مسرحيات الحكيم أو شكسبير أو خمس من روايات مينة أو ماركيز؟! لأثبت له مقدرتي الفائقة التي لا تنازع ولا تقارع… لكنه سألني فيما أنا محجم ومنصرف عنه للأسف.
أو عندما أقمت ثلاثة معارض للرسم التشكيلي، ولكم أن تعرفوا مدى حرصي على الفن وخيبتي في العلم، وأنا أقدم للفلاحين الفن التشكيلي الذي خرجت منه بعلاقات نسائية رائعة، جميلة، ذات فائدة وخبرة جعلت مني أتخرج من صفوفها الراقية النهائية وأنا ما زلت في المرحلة الأولى من عهد الدراسة في الجامعة… لقد كانت علاقات فذة وحميمة!!
انتشر صيتي في القسم الذي أدرس فيه… على أني الطالب الذي يفحم الأساتذة بأسئلته!! ولكن ما نوع هذه الأسئلة التي يقصدون؟
إنها أسئلة مخربة… هدفها تضييع الوقت، وتأخير الدرس، ونشر الفوضى في قاعة المحاضرات!!
إذ تعودت مع الوقت وبخبث لا أعلم كيف أتاني ولا من أين، أن أوجه للأساتذة المحاضرين أسئلة صعبة ومعقدة وأغلبها مصطلحات لا ترحم ولا تغني وأطلب تفسيراً لها… فيعجز الأستاذ عن الإجابة عليها وهو صاغر!! وهكذا بدأت أتفنن في البحث عن المصطلحات المعقدة الغريبة التي لا تخطر على بال… كي أهيئ نفسي لدفعها في قاعة الدرس عن مكر، بحثاً عن تضييع الوقت، والطلبة يتغنون وينشدون هذه الحركات بعد أن أعجبتهم اللعبة… يا لها من لعبة كنا فيها الخاسرين دائماً!! هذا ما ذكرته في شخصية فارس في قصة صورة الرئيس في مجموعتي القصصية الأولى.
ولكن لا يبقى شيء على حاله، وهكذا تجاوزت المرحلة الجامعية وأنا لا أنشد سوى الأدب الضائع مني! بعدها قررت السفر إلى خارج أسوار الوطن، وأنا لا أملك سوى أوراق تثبت أني مهندس زراعي، ولكن بمقدرة علمية ضحلة لا تكاد تذكر، وبتفوق أدبي طاغ عجيب!!
لم تمض على إقامتي في ميونخ سوى أسابيع، حتى كنت أحد أفضل زبائن مكتبة جامعة ميونخ القسم الشرقي الرائع، والذي تديره امرأة ألمانية حاصلة على شهادة دكتوراه في اللغة العربية؛ وسرعان ما شعرت بتواجدي المستمر شبة اليومي في قاعة المكتبة وكأنني أسكن فيها! فبادرتني بالسؤال باستغراب وحيرة: لماذا أنت هنا؟!
ثم استطردت بجد وحزم: لقد اطلعت على هويتك والمعلومات المدونة فيها واتضح بأنك صائغ ذهب ومتخرج من صفوف كلية الزراعة، ولكنك لا تأتي إلى هنا لتقرأ ما يتعلق باختصاصك؟!
ابتسمت غامزاً، ماكراً، وتذكرت الأسئلة التي كنت أوجهها لأساتذتي الأفاضل، وقلت بإيجاز مقتصد:
ما أقرأه هو الأدب العربي، وأنا كما ترين من بلاد العرب… إذن، فأنا أقرأ لبلادنا فهو بالتالي أدبنا!! فضحكت وأصبحنا كالصديقين، أسألها عن كتب أتوق لقراءتها في العراق ولم أجدها، لكنها كانت تحضرها لي عن طيب خاطر عجيب وكأنها أمي!! حتى وإن كانت تلك الكتب النسخة الوحيدة المعتمدة والموجودة في مكتبة الجامعة…
يا لها من إنسانة تفهمت معنى الشعور الذي يخالج من يحب الأدب حد العشق… حباً لا يبارى ولا يتزعزع ولا يتنازل أو يتهاون ولا تختلف أو تضعف درجاته بالقدم! بل العكس تماماً، فكلما تعمقت كلما اكتشفت أسراراً جديدة… تعطيني دفعة البحث وبقوة أكبر وبطاقة وشوق عارمين… هذا هو الأدب الذي أعرفه وعشقته حد الإيمان والعبادة وكأنه إله الكون!!
تراكمت مسؤولياتي في الغربة سريعاً، وأصبحت فجأة شخصاً يسعى للرزق كي يعيش! قلت قراءاتي ولم أهملها…
بدأت أكتب المقال والقصة القصيرة ولكن بشكل مضحك لا يمت لشروط وأساسيات وقواعد فن الكتابة… لكنها نشرت لي رغم فقرها وبساطتها، ثم قمت وبمساعدة زوجتي بتأسيس مجلة فصلية ناطقة باللغة العربية تهتم بالقضايا الاجتماعية والدينية والأدبية والعلمية وكانت تباع بسعر تكاليفها والهدف منها كان:
أن أبقى إلى جانب الأدب والقراءة والكتابة، كيلا أموت!!
أصبحت قراءاتي موجهة، بعد أن كانت مبعثرة، لا تعرف طريقاً واضحاً لها؛ وأكثر ما كان يفرحني هو عندما تعلمت أسلوباً جديداً في القراءة، وهو: أن أقتني كل ما أستطيع للكاتب الذي أنوي أن أتفرغ وأقرأ له… وبعد أن أحصل على مؤلفاته، أقرؤها تباعاً دون انقطاع أو توقف… الكتاب تلو الآخر، حتى أفرغ من الكاتب ومؤلفاته… عندها أكون قد عرفت عنه كل شيء، حتى ما يحبه من طعام وما هو شرابه المفضل!!
فكرت يوماً بدراسة شخصية يوحنا المعمدان… ولم أجد نفسي بعد حين، إلا غارقاً في بحر الأديان دون إرادة وكأني منوم مغناطيسياً… ابتعت كل ما توفر من مؤلفات تخص أديان الشرق القديمة وبدأت الغوص فيها…
استغرقت في البحث والتنقيب والتفسير والتحليل مدة لم تقل عن أربع سنوات متواصلة دون انقطاع… بعدها كتبت ملاحظاتي التي خرجت فيها في كتاب تحت عنوان (الدين والنبي في التاريخ) في مائتين وثمانين صفحة دون صور!!
وخلال تلك الفترة الحرجة التي استهلكت فيها طاقة تجاوزت حدود قدرتي الجسمانية… تعرفت بالصدفة، بعد أن نصحني صديق لي بالكتابة إلى موقع إلكتروني اسمه مندائين كروب… وكانت البداية والانطلاقة التي جعلت مني أدخل حقل المنافسة بعد أن وجدت هناك من يكتب القصة القصيرة كذلك، فاشتد حماسي وقبلت التحدي…
كتبت دون ملل وبحيوية تتسم بالنشاط والهمة العالية بعد أن تركزت قراءاتي ودراستي في مجال القصة القصيرة، ولا انسى فضل وجهد من كان يحثني على المواصلة أو من كان يقدم لي يد العون والنصيحة دون مقابل، وأخص بالذكر الأديب الفنان المسرحي (مديح زامل الصادق) لما كان له من أثر وتأثير على نفسيتي وكتاباتي وحتى أفكاري في الكتابة؛ فيا لهم من أصدقاء أوفياء قل مثيلهم في عالم لا يعرف اليوم سوى المال لغةً، ولا يتخذون سوى المصلحة الذاتية مذهباً في حياتهم! كما لا يفوتني أن أذكر تشجيع زوجتي ووقوفها بجانبي وهي تختار لي عناوين القصص بعد أن تقرأها بكل دقة وحذر وكأنها تسير على حبلٍ مشدود.
هذه هي حكايتي في رحلتي مع الكتابة، ومشوارها الذي سوف لن ينتهي، إلا بانتهاء حياتي.