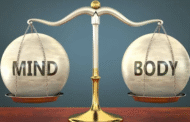نبدأ مقالتنا هذه بإدانة تلك السلوكيات الموجعة للقلب التي شاهدناها في التقارير الإعلامية التي أعدّتها الصحفية الشابة حنان خندقجي وتلفزيون ال BBC العربي حول إساءة معاملة بعض الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية في الأردن ونطالب بإيقاع العقاب المناسب بحق كل من ارتكبها، فالاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة اعتداء على حقوق.
الإنسان وعلى الطفولة وعلى مسيرة التربية الخاصة الأردنية، ونذكّر بأن إساءة المعاملة قد تكون أحد أسباب الإعاقة لدى بعض الأطفال فعدة تقارير دولية أشارت إلى أن حوالي ?25 من الإعاقات لدى الأطفال تنتج عن إساءة المعاملة والإهمال.
كأنه لا يكفي هؤلاء الأطفال ما لاقوه في مجتمعهم وربما في أسرهم من تمييز ورفض ومعاملة قاسية، وكأنه لا يكفينا في المراكز والمؤسسات فضائح تشخيص الإعاقة، والمناهج الخاوية، وبعض مشاريع (الدمج) الأكثر سوءاَ من العزل، والممارسات التعليمية المثيرة للشفقة، وفي حين أن العالم المتقدم ينفذ مناهج لتعليم الأشخاص المعوقين مهارات الحياة ومهارات تقرير المصير ما زلنا نحن نصفق لطفل لديه إعاقة بسيطة لأنه يعرف إسمه، غيرنا يحوّل الإعاقة الشديدة إلى متوسطة وربما بسيطة ونحن نجعل بجهلنا وسوء معاملتنا مشكلات الأطفال تتفاقم، هم يطوّرون الاستقلالية ونحن نرسخ الاعتمادية.
إن تلك الممارسات المذمومة التي تعكس منظومة قيمية خاوية على عروشها مرفوضة ولا يمكن قبولها أو تبريرها، فلا الصعوبات التي ينطوي عليها تعليم بعض الأطفال ذوي الإعاقة تبررها، ولا ظروف العمل القاسية، ولا تدني الرواتب، ولا الإدارات الظالمة وغير الداعمة، ولا أي عامل آخر، وقد خفّف من إحساسنا بالإحباط أن استجابة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين جاءت فورية حيث وجّه رسالة سامية للحكومة الأردنية يوم الاثنين الموافق 14 أيار / مايو عبّر فيها عن غضبه واستيائه الشديدين من تعرّض هذه الفئة العزيزة لإساءات وانتهاكات، وأكّد جلالته أن كرامة الإنسان خط أحمر وفوق كل اعتبار ووجه الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق ولتقييم عمل المراكز الخاصة والعامة، وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لتحويل كل من يثبت تورطه بارتكاب تجاوزات وانتهاكات إلى القضاء.
وهنا نقول إن ما أشعرنا بالذهول عدم تدخل معظم (المتخصصين) وعدم تعقيبهم على ما جرى في الفترة الماضية من أمور تطال مهنتهم (التربية الخاصة)، وهو ما جعلنا نتساءل عن علاقة المتخصص بمهنته، ألا ينبغي على المتخصص أن ينتمي لمهنته ويهتم بسمعتها ويحرص على توصيل المفاهيم الصحيحة عنها.
لا ندري كيف نفسر ذلك الصمت، ويبدو لنا أننا خرّجنا أعداداً كبيرة ممن لا يعرفون مهنتهم ولا ينتمون إليها، وما زال كثيرون في دولنا العربية يتهجّون أبجدية التربية الخاصة، معاق، معوق، ذو إعاقة، ذو احتياجات خاصة، ذو تحديات وهكذا دواليك منذ ثلاثة عقود، أما الأشخاص الذين يفترض بنا دعمهم فقد نسيناهم.
التربية الخاصة مهنة لها مدونة سلوك مهني وأخلاقي من أكثر المدونات رقياً، فكوادر التربية الخاصة تلتزم بتطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحد الأقصى الممكن، وتسهم في الأنشطة التي تعود بالفائدة عليهم وعلى أسرهم، وتحرص على الدفاع عنهم وعلى تحسين القوانين التي تنظم عملية تقديم الخدمات لهم، ولا تشارك في ممارسات غير أخلاقية أو غير قانونية.
هذه هي التربية الخاصة التي يؤمن بها السواد الأعظم من معلمينا، وأهم من ذلك، أن ديننا الحنيف يدعونا إلى التعامل برحمة مع ضعفائنا والعطف على صغارنا، ولا نعرف كيف زرعت هذه المنظومة القيميّة الممسوخة في أولئك الذين رأيناهم يسيئون بطريقة بشعة للأطفال ولسنا متأكدين أي نماذج أخلاقية قدّمت لهم. ولا نعرف كيف سمح لهم باختراق جسم التربية الخاصة؟
ولكن لنتذكر أن من أساء للأطفال ليس نظام التربية الخاصة نفسه، فتوفير بيئة إنسانية آمنة، وإيجابية، ومتقبلة، وصحية هو حجر الأساس في تعليم هؤلاء الأطفال. وليس لمن أساؤوا أن يدّعوا أن تصرفاتهم غير الإنسانية هي أساليب لتعديل السلوك فعلم تعديل السوك والتربية الخاصة منهم براء، ونذكّر الجميع أن التربية الخاصة لم تكن يوماً عملاً سهلاً ولا يتقنها إلا من كان متخصصاً وذا خبرة، وندعو كل من لا يقبل أو يفهم هؤلاء الأطفال أو يعجز عن تعليمهم بشكل فعال أن يبحث له عن مكان آخر يسقط فيه إخفاقاته وإحباطاته، وفي الوقت ذاته، ندعو خفافيش الظلام إلى أن يتقوا الله فلا يترزقوا على مآسي الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في أية دولة من دول العالم.
ومن حقنا أن نسأل: ألا يعرف (المسؤولون والمتخصصون) أن الأطفال ذوي الإعاقة في العالم كله عرضة لإساءة المعاملة؟ لماذا لم يتوقعوا حدوثها فيخططوا للوقاية منها، ويطوروا آليات عملية لرصدها والتبليغ عنها، ويتخذوا إجراءات قانونية رادعة بحق من يثبت ارتكابه لها؟ ليس مقبولاً أن يقولوا: من يصدّق أن من توكل إليهم مسؤولية رعايتهم هم الذين ينتهكون حقوقهم ويتسببون في تفاقم مشكلاتهم وتدهور صحتهم النفسية؟ ألم يطّلعوا على عشرات التقارير التي أشارت إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة في العالم يتعرضون لأنواع شتى من العنف والإساءة لأن ضعفهم يجعل البعض يرى فيهم هدفاً سهلاً.
ألم يطّلعوا على التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة التي قدّمت أرقاماً مفزعة عن تعرض هؤلاء الأطفال لإساءة المعاملة في كل دول العالم، ألا يعرفون أن إساءة معاملة هؤلاء الأطفال قد تحدث في كل من البيت، والشارع، والمركز أو دار الرعاية، ألا يدركون أن النقص في أعداد الكوادر وضعف تأهيلها، وتدني رواتبها، وتعدد مسؤولياتها، واكتظاظ دور الرعاية، وقلة الإشراف، وساعات العمل اليومي الطويلة، وغياب إجراءات المساءلة، وعدم فهم خصائص الأطفال ذوي الإعاقة، وعوامل عديدة أخرى قد تكمن وراء مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية وغير الحضارية؟
ما حدث يفرض علينا أن نطرح العديد من الأسئلة عن التربية الخاصة. فمن الذين يعلّمون أطفالنا ذوي الإعاقة؟ وماذا يعلّمونهم؟ وهل هذا التعليم ذو معنى وفائدة حقاً؟ ومن الذي يشرف فعلياً على هذا الميدان؟ ولا نريد أن يقتصر الاهتمام على إساءة المعاملة فقط. فما نصبوا إليه يتجاوز عدم الإساءة، علينا التحلي بالجرأة وإعادة التفكير بأمور كثيرة، فلنمنع من لا يريد أو لا يستطيع أن يعلّم هؤلاء الأطفال شيئاً من دخول ميدان التربية الخاصة أو البقاء فيه، ولنبذل مزيداً من الجهود لتطوير الاتجاهات نحو الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتنا. فذلك ليس بأقل أهمية من القوانين.
لنُعد تنظيم هيكلة التربية الخاصة، فتعدد الجهات المسؤولة وغموض أدوارها وتداخله ينجم عنه خلل يجب إصلاحه حيث أصبحت كل جهة ترمي الكرة في ملعب الأخرى، ولنعالج المشكلات الناجمة عن تعدد المرجعيات وأساليبها في الترخيص والإشراف وعدم فهم مضامين قوانين حقوق الأشخاص المعوقين بسبب عدم تفسير موادها ووضع أسس وآليات عمل واضحة تضمن حسن التطبيق وتعريض المخالفين لها للمساءلة.
ولنبدأ بإجراءات فورية لتنظيم مزاولة مهنة التربية الخاصة وإصدار تراخيص مهنية وتجديد هذه التراخيص دورياَ وفق آليات مساءلة متطورة ليتم التخلص من الوهن الذي أصاب جسم التربية الخاصة، فالشهادة الجامعية بذاتها ليست ضمانة لممارسة جيدة في الميدان، وقد تكون اتجاهات المعلم وتوقعاته من الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر أهمية من الشهادة التي يحملها.
علينا إعادة النظر في برامج التربية الخاصة في جامعاتنا بحيث تتاح الفرصة لدراسة التربية الخاصة لطلبة لديهم الخصائص والاتجاهات والقيم المطلوبة. وعلينا أن نعيد النظر في خططنا الدراسية في الجامعات. فلا نظن أن أية جامعة من جامعاتنا تدرّس مادة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو عن أخلاقيات مهنة التربية الخاصة، ولعلنا أيضاَ نحتاج إلى تدريس مادة عن ضغوط العمل في التربية الخاصة وسبل التعامل معها، وأخرى عن الاتجاهات نحو الأشخاص ذوي الإعاقة، ونرجو أن يذكّرنا ما حدث بأهمية تكثيف الجهود الموجهة نحو أسر الأطفال ذوي الإعاقة وبإقامة علاقات تشاركية معها وكحد أدنى أن نعرّفها بحقوق أبنائها بكافة الوسائل الممكنة وأن نوضح لها دورها وندعمها في حماية هذه الحقوق.
ولنُعط اهتماماً أكبر ببرامج التنمية المهنية المستمرة للمعلمين في الميدان، وبمعنوياتهم وبتحسين ظروف عملهم، ولنعترف أن العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة عمل إنساني نبيل ينطوي على قدر كبير من المكافآت المعنوية، إلا أنه أيضاَ عمل قد يقود إلى الاستنفاد النفسي والجسدي، فقد أشار تقرير حديث نسبياً إلى أن متوسط العمر الوظيفي لمعلمي التربية الخاصة في أمريكا وكندا يبلغ خمس سنوات، لذا علينا أن نعي هذه الحقائق فنتخذ الإجراءات الوقائية والعلاجية المناسبة.
ولنُعد النظر في آلية ترخيص مراكز التربية الخاصة، ومتابعتها، والإشراف عليها، فلا ينبغي أن يسمح لمن ليس لديه مؤهل علمي متقدم في التربية وخبرة واسعة في العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة أن يدير مؤسسة للتربية الخاصة حتى لو كان هو مموّلها، ولا ينبغي أن يسمح بالتحايل على القانون لتعيين مدراء على الورق فقط، ولا بد من رقابة حقيقية على برامج التربية الخاصة وفق أسس متطورة بدلاَ من الاكتفاء بتقارير مكتوبة تعدّها المراكز والمؤسسات.
كما أن الحاجة ماسة لإعادة النظر في التعيينات في هذه المراكز، وندعو أيضاً إلى إعادة النظر في دور وزارة التنمية الإجتماعية وعلاقتها بالتربية الخاصة، فإبقاء مسؤولية تعليم الأطفال ذوي الإعاقة العقلية بعيداً عن السلطة التربوية الوطنية ليس قراراً صائباً، فالغالبية العظمى من الأطفال ذوي الإعاقات العقلية لديهم إعاقات بسيطة ويستطيعون تلقي كل أو معظم تعليمهم الذي هو حق لهم يكفله القانون الأردني في مدارس نظامية.
وليصبح حجم الدعم المالي الحكومي للمراكز متوقفاً على نوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وعلى تقييم موضوعي للتقدم الذي يحرزونه من قبل لجان علمية متخصصة لا بناء على تقارير قد تكون مفبركة تعدّها هذه المراكز، ونذكّر بأن المباني مهمة لكن ما هو أكثر أهمية منها الكوادر، والبرامج، والمناهج، وأساليب التدريس، والوسائل والمعدات، ونحن بحاجة إلى معلمين متخصصين في كل فئة من فئات الإعاقة، وإلى معلمين مستشارين ومتنقلين ذوي حبرة يعملون في الميدان وليس في مكاتبهم. وقد يقول قائل أن الدمج هو الحل، وذلك قول سهل لكن طريق الدمج لم يكن يوماَ مكللاً بالورود، فلنعرف أن الدمج يفرض تحديات جمة وليكن دمجنا دمجاً مخططاً له ومنفذاَ وفق معايير الجودة والممارسات المناسبة.
عذراً لأولئك الأطفال الأعزاء الذين رأيناهم يصرخون مذعورين مستغيثين ولم يكن أحد إلى جانبهم يحميهم، وعذراً وتحية لمعلمي التربية الخاصة المحترمين، وما أكثرهم، الذين نجزم أن تلك المشاهد خذلتهم كما خذلتنا.
وأخيراً، ولغايات تطوير الوعي بحجم هذه المشكلة على مستوى العالم ونحن جزء منه، نناشد جميع ذوي العلاقة بمواصلة التحقيق في إساءة معاملة الأطفال ذوي الإعاقة وكشفها، وندعو للاطلاع على تقرير سكرتير عام الأمم المتحدة عام 2005 المعنون «العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة» وغيره من التقارير الدولية لتقديم الحقائق لمجتمعاتنا ولبذل كل جهد ممكن للتصدي لهذه المشكلة بالغة الخطورة، فقد كان أحد مسوغات الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2007 ولا يزال الاعتراف بأنهم غالبا ما يواجهون خطراً أكبر في التعرض للعنف أو الإصابة أو الاعتداء أو الإهمال أو المعاملة غير اللائقة وسوء المعاملة أو الاستغلال.