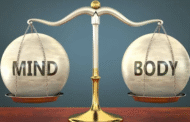بقلم د. روحي عبدات
كثيراً ما يتم استخدام مصطلحي التشخيص والتقييم في مجال الإعاقة كمرادفين، أو كمفهومين مكملين لبعضهما، وليس الهدف من هذا المقال هو تغليب أهمية أي منهما على الآخر، وإنما توضيح استخدامهما في المكان الصحيح والوقت المناسب، بما يضمن تحديد الاحتياجات اللازمة لكل مستفيد وتقديم الخدمات الضرورية له.
لقد درج استخدام مصطلح (التشخيص) في عالم الطب بناءً على قائمة من الأعراض المتزامنة، والتي تكوِّن بمجملها مرضاً معيناً أو متلازمة وراثية تستوجب العلاج أو التأهيل، ومن هنا شاع استخدامه في عالم الإعاقة لتحديد مجموعة من المعالم التشخيصية التي تضع الشخص تحت مظلة إعاقة ما أو اضطراب معين.
وبالتالي يستند التشخيص في عالم الإعاقة إلى مجموعة من الأعراض التشخيصية التي تظهر بشكل أو وقت معين كما أسلفنا والتي على أثرها يتم الحكم على وجود الإعاقة، إلا أن هذا المصطلح لم يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك لتحديد مجموعة القدرات والمهارات ومدى قدرة وظائف الجسم على العمل بدرجة ملائمة في الحياة العامة، وبالتالي تحديد النقاط الهامة التي تحتاج إلى متابعة، ومواطن القوة أيضاً عند الشخص والتي ستستند إليها برامج التأهيل وخطط التدخل فيما بعد، علماً أن الوقوف عند مصطلح تشخيصي معين (كالتوحد، أو الإعاقة الذهينة) لا يكفي وحده، إذا اتفقنا أن هناك فروقاً فردية قد تكون شاسعة بين قدرات الأفراد الذين يقعون تحت نفس التشخيص، والتي تحدد مسارات تأهيلية وتدخلية مختلفة تماماً بينهم.
من هنا تأتي أهمية المضي قدماً إلى ما هو أبعد من التشخيص عبر عملية مستمرة ومعمقة وهي (التقييم) لمساعدتنا على تحديد مجموعة المهارات الوظيفية التي يمتلكها الشخص والتي تؤدي علمها في الحياة اليومية، وطبيعة الاحتياجات اللازمة لبناء خطة التدخل التأهيلية بما يتوافق مع مجموعة الظروف البيئية التي يعيشها.
هذا التقييم يشترك فيه فريق متكامل من الاختصاصيين الذين يدرسون الحالة معاً ومن أوجه مختلفة كالمعالج الطبيعي والوظيفي واللغوي والنفسي، لدراسة القدرات التواصلية، والحركية، والمعرفية، والاجتماعية عند الشخص، والطريقة التي تتفاعل فيها مع بعضها ومع البيئة التي يعيش فيها، حيث أن تحديد هذه القدرات لا يتم بمعزل عن البيئة الاجتماعية التي قد تكون داعمة أو معيقة للشخص، أو البيئة العمرانية التي تسهم في تسهيل تنقله وحركته أو العكس.
يتوسع التقييم عبر المكان ليصل إلى بيئات أكثر تنوعاً وخروجاً عن البيئة الإكلينيكية المقننة التي قد لا يستجيب فيها الشخص بشكل طبيعي، ليصل إلى البيئات الطبيعية التي يعيش فيها، ويتنوع أيضاً من حيث الزمان ليمتد بالشخص عبر المراحل العمرية التي يعيشها مع تفهُّم أن لكل مرحلة عمرية احتياجاتها المختلفة والمتطورة، وضمن البعد الزمني للتقييم وقته وطول الفترة التي يمتد فيها ليعكس المهارات التي يتمتع بها أو التي يحتاج فيها الشخص للدعم والمساندة.
أما من حيث أدوات التقييم فهي كثيرة ومتنوعة وتختلف من بيئة إلى أخرى يعيش فيها الشخص، والشيء المهم بالنسبة لها أن تكون قادرة على الكشف والتعرف على القدرات في الوضع العادي الذي يعيشه الشخص وملاءمتها لبيئته الثقافية، وقد تكون منها الأدوات الرسمية المقننة والمتعارف عليها بين الاختصاصيين أو غير الرسمية التي يبتكرها الاختصاصيون من واقع الحياة اليومية.
ولعل التنوع في استخدام أدوات جمع البيانات من شأنه أن يؤدي إلى التنوع فيها كماً وكيفاً، وإمكانية رؤية القدرات من زوايا متعددة، مما يعطي صورة أكثر شمولاً عن الشخص في مواقف متعددة، وقد تشمل هذه الأدوات الاختبارات المقننة، أو الملاحظة في البيئات الطبيعية، أو المقابلات الشخصية أو غيرها من الأدوات ولضمان مصداقية التقييم والاطلاع على تطور الحالة منذ بدايتها، فمن المفيد الاطلاع على التاريخ الطبي والاجتماعي والتعليمي للشخص، لضمان نظرة ذات عمق زمني في التقييم تساهم في توقع مستقبل الحالة وتستشرف الخدمات اللازمة لها.
لا بد لأهداف التشخيص والتقييم من مراعاة احتياجات الشخص، فتكمن قوة التقييم في قدرته على تحديد مواطن القوة عن الشخص لاستثمارها والبناء عليها، وتحديد مواطن الضعف من أجل التركيز عليها وتحسينها من خلال بناء خطة التدخل التأهيلي المناسبة، فيكون للتقييم هنا فائدة عظيمة في رسم خارطة طريق الخدمات والاحتياجات اللازمة للشخص في الوقت الحالي أو على المدى البعيد، مثل الخدمات الصحية، التعليمية، الوظيفية، والاجتماعية وغيرها.
ويتميز التقييم بأنه تراكمي ومتطور مع الزمن، يواكب الاحتياجات المتنامية مع العمر، لذلك فهو مستمر وتتبعي بتطور الحالة مع مرور الوقت، وبذلك يعدل مسار خطط التأهيل والتدخل التي يحتاجها كل شخص على حدة.
من هنا، وقد أدركنا عمق عملية التقييم وقدرتها على تحديد مواطن الاحتياج والخدمات اللازمة للشخص، قد يكون من غير المهم في بعض الأحيان إطلاق مسميات تشخيصية على الفرد في وقت مبكر قد تنعكس آثارها على المدى البعيد مثل كلمة (توحد، أو إعاقة ذهنية، أو حتى صعوبات تعلم)، في الوقت الذي تبرز فيه الحاجة لتقديم الخدمات لهؤلاء الأشخاص أكثر من الحاجة لوسمهم بمسميات تشخيصية قد تكون فيهم أو لا تكون.
إن التريث في التشخيص قد يفتح الباب أمام عملية تقييم مستمرة تواكب تطورات الحالة وتلبي احتياجاتها المتغيرة مع الزمن، وبغض النظر إن كانت تنطبق على الحالة تلك المسميات التشخيصية أو لا، فالمهم أولاً وأخيراً هو تحديد الاحتياجات ورسم الخطة التأهيلية التدخلية التي تلبيها وتمكّن الشخص من التطور والنمو المستمر في حياته.
- دكتوراه الفلسفة في التعليم الخاص والدامج ـ الجامعة البريطانية بدبي
- يعمل حالياً في إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم ـ وزارة تنمية المجتمع ـ دبي.
- له العديد من المؤلفات حول التقييم والتأهيل النفسي والتربوي وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
- باحث مشارك مع مجموعة من الباحثين في جامعة الامارات العربية المتحدة للعديد من الدراسات المنشورة في مجال التربية الخاصة.
- ألقى العديد من المحاضرات والدورات وشارك في الكثير من المؤتمرات حول مواضيع مشكلات الأطفال السلوكية، وأسر الأشخاص المعاقين، والتقييم النفسي التربوي، التشغيل، التدخل المبكر.
- سكرتير تحرير مجلة عالمي الصادرة عن وزارة تنمية المجتمع في الإمارات.
- سكرتير تحرير مجلة كن صديقي للأطفال.
جوائز:
- جائزة الشارقة للعمل التطوعي 2008، 2011
- جائزة راشد للبحوث والدراسات الإنسانية 2009
- جائزة دبي للنقل المستدام 2009
- جائزة الناموس من وزارة الشؤون الاجتماعية 2010
- جائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة 2010
- جائزة العويس للإبداع العلمي 2011