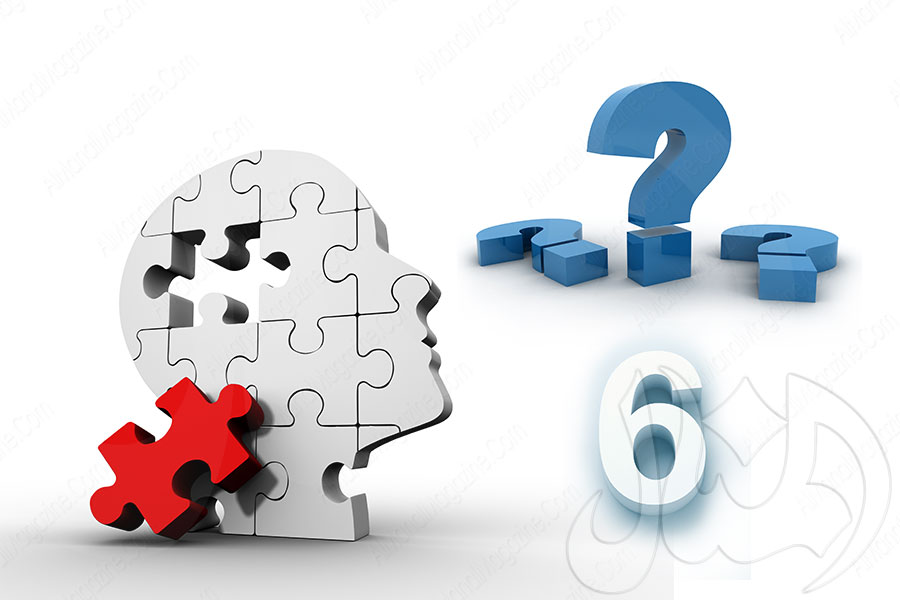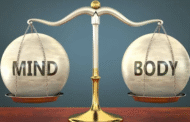قالها الصغير قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة:
اذرفوا دموعكم بعد موتي.. وليس قبله!
كنت جالسة في مكتبي في القسم النسائي من الصحيفة أجري بعض الاتصالات بالجهات الصحية المختلفة للحصول على معلومات عن تحضيرات أو ندوات أو مؤتمرات طبية لكي أقوم بإجراء التغطية المعتادة لها.
وفي هذه اللحظة جاءنا تعميم عاجل من رئيس التحرير بترك كل ما لدينا من أحداث وتغطيات والتحرك بسرعة لعمل التغطيات اللازمة حول الاستعداد لليوم العالمي للإيدز والذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام.
لا أدري ما حدث لي في هذه اللحظة، فقد شعرت بزائر الضيق والضجر يدق باب ذاكرتي وكأنه يريدني أن أتذكر واقعة حاولت نسيانها بعد أن وضعتها في أرشيف الذاكرة ومنعت أي موظف في دائرة الحاضر من اخراجها واسترجاعها مهما حدث.. لماذا؟! لن أخفيكم القول إذا ذكرت لكم السبب.. القصة تبدأ قبل عامين بالتحديد عندما كنت في إحدى الدول (…) التقيت صدفة بأسرة عربية تقيم فيها ومكونة من أب وأم وعدد من الأطفال الصغار لم يتجاوز أكبرهم التسعة أعوام.
كانت الأسرة التي التقيت بها في مستشفى (…) لعلاج طفلها البكر. وعلى السرير الأبيض كان يسجى جسده الضعيف الواهن الذي احتضر كل ما فيه عدا روحه التي أبت أن تقدم استقالة الاحتضار من هذه الحياة التي جاءتها طفلة، وسترحل عنها طفلة أيضاً!!
.. وعلى السرير المجاور كانت أمه تجلس وهي تنظر إلى طفلها.. تحاول أن تمنع أمومتها من الاحتضار هي الأخرى.. تبكي تارة.. وتبتسم تارات عديدة حين تلتقي عيناها بعيني فلذة كبدها اللتين ذبلتا من المرض.
نظرت إليها مبتسمة ومستغربة.. فضولي الصحفي لم يحجب عني في هذه اللحظة الإنسانية تساؤلاً وعلامة استفهام حول ما يجري من حولي.. المشهد الذي كان أمامي ليس كباقي المشاهد التي أراها في أروقة المستشفيات أو على الأسرة البيضاء.
دموع الأم المنهمرة بشدة منعتها من الإجابة على سؤالي مما جعلني أردد السؤال نفسه ولكن بصيغة توسل.. قلت لها: لماذا تبكين؟
نظرت إليّ هذه المرأة بحقد، وبدل أن أسمع رداً على سؤالي جاءتني اجابتها على صيغة هجوم لم أتوقعه: من الذي بعثك؟ هل جئت لتنشري قصتنا في الصحف.. هكذا أنتم الصحفيون فضوليون وتحبون الفضائح طالما أنها ستعطيكم كل ما يشبع جوع صحافتكم البعيدة عن الانسانية..
هنا حاولت بطريقة لبقة أن أوقف سيل تلك الكلمات التي جرحت انسانيتي قبل أن تجرح قلمي الصحفي.. سألتها مجيبة: عمن تتحدثين؟ ومن هم الذين بعثوني إليك لأنشر قصتك وأفضحك؟
أجابت: الذين يمنعوني من أخذ حقي لأنهم السبب فيما حدث.
سألتها لماذا، ولكنها لم تجب وعادت إلى بكائها. وعندما لم أجد رداً من الأم اتجهت إلى الصغير الذي أيقظني صوته من دوامة الاستغراب التي دخلتها بلحظة وهو يهدئ من روع أمه قائلاً: لا تبكي يا أمي فأنا ما زلت بخير وأعيش.. قلت له: ما اسمك؟ أجاب: (…) وبابتسامة هادئة سألته: لماذا أنت في المستشفى (يا ….) أجابني بابتسامة شاحبة صفراء اعتقد أنها هي الأخرى تحتضر على قارعة فمه: «لأني مريض ومش رح أعيش أكثر من أشهر قليلة».
أصبت بالذهول، ولكني تمالكت نفسي وأخذت أفكر أن الصبي قد يكون مريضاً بالسرطان أو بأي مرض آخر خطير أو.. لم يتركني الصبي لحيرتي طويلاً فسرعان ما قال لي: «أنا مصاب بالإيدز ـ كما يقولون».
هنا لم أتمالك نفسي وطفرت دمعتان من عيني المذهولتين.. كيف ذلك؟! طفل في التاسعة مصاب بالإيدز!! من أين له الإصابة بهذا المرض! ومن الذي نقله إليه!!
نظرت إلى أمه التي زادت من وتيرة بكائها قبل أن تزيح ستار الغموض والصمت بالدفاع عن نفسها عندما قالت بكلمات مبللة: لا يذهب فكرك لبعيد، فهذه قصة طويلة لا داعي لأن أحكيها لك، ولكن باختصار أقول: قبل ثمانية أعوام عندما كان (….) عمره سنة واحدة حدث له نزيف فذهبنا به إلى إحدى المستشفيات واسمها (….) وهناك تمت له عملية نقل دم، ولم نكن نعلم أن اكسير الحياة (الدم) أصبح سماً لابني الذي يحتضر الآن، كما تشاهدينه. ـ قالتها بصوت خفيض حتى لا يسمعها الطفل الذي كان يلهو بألعابه في سعادة مؤقتة.
وأضافت الأم وكأنها تتذكر: صدقيني لم نكن نعلم أن هذا الدم ملوث بهذا الفيروس اللعين.. وكيف لي أنا وأبوه أن نعرف أنه ملوث أو يحمل فيروس الإيدز.. لقد انتهى الأمر فقد سجل هذا الدم الملوث نهاية طفلي البريء.
قلت لها: ولماذا لم تكتشفوا المرض سريعاً لتتمكنوا من علاجه؟
أجابتني والدموع بعينيها: من أين لي أن أعرف أنه مصاب بالإيدز.. كل ما عرفناه هو ضعف عام في قوته البدنية وفقدان الشهية وعرق وصداع مع هزال عام واسهال واحتقان في الحلق وحمرة في الجلد مع تورم في الغدد اللمفاوية وكنا نظنها أمراض أخرى غير الإيدز حتى عرضناه على الطبيب الذي صعق من هذه الأعراض وطلب منا على الفور اجراء اختبار ELISA لمعرفة ما إذا كانت هناك أجسام مضادة للفيروس أم أنها الفيروس واختبار Western للتأكد من خلو هذه الأجسام من فيروس نقص المناعة.
وبعد ظهور النتائج النهائية اكتشفنا الكارثة المفجعة: الطفل مصاب بمرض الإيدز..
ومرة أخرى أجهشت الأم بالبكاء.. حاولت تهدئتها فسألتها: هل طلبتم تعويضاً عن هذا الخطأ القاتل؟
أجابت: فعلنا ذلك، كنا نهدف من وراء هذا المبلغ تأمين مصاريف علاجه في الخارج، علنا نجد العلاج والشفاء وكله بيد الله سبحانه وتعالى. إلا أن المستشفى رفض إعطاءنا التعويض بحجة عدم مسؤوليته عن ذلك الخطأ لأن المستشفى قد اشترى الدم من الخارج!!
.. بعدها ماذا فعلتم؟.. كان هذا هو سؤالي الأخير لها.
تنهدت الأم بحسرة وقالت: فوضنا أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى الذي سوف يأخذ حقنا من هؤلاء الظلمة الجبابرة الذين انعدمت الرحمة من قلوبهم وبدلاً منها استقرت القسوة والظلم وعدم المبالاة بالأرواح التي تضيع كل يوم بسبب هذه الأخطاء التي كان من الممكن تداركها.. لولا اهمالهم وعدم تحملهم للمسؤولية التي أمنهم الله عليها. (ومرة أخرى عادت إلى البكاء).
أحسست أن وجودي في هذه الغرفة لم يعد مجدياً وكأنني أضع الملح على الجرح.. ومع هذا أحسست أن القصة لم تكتمل بعد فسألتها: كم بقي على حياة ابنك؟ وماذا ستفعلون في أسوأ الأحوال؟ وهل ستواصلون شكواكم للمسؤولين لمقاضاة المتسببين في هذه المأساة؟
لم تجبني الأم فشعرت بالحرج وتهيأت للانصراف ولكن الطفل الصغير ناداني بصوت عذب ماداً يده لي بعلبة الشكولاتة يطلب مني أخذ واحدة فأخذتها واقتربت منه وجلست جواره على السرير، فسعد بذلك لأن الجميع من حوله ابتعدوا عنه لإصابته بهذا المرض.
نسيت للحظة أنه مريض فسألته عن دراسته وعمره وأسماء أشقائه وأعمارهم، وكان يجيب عليها وهو سعيد جداً، وقال لي: لأول مرة أشعر بهذه السعادة التي فقدتها منذ أشهر خاصة بعد أن تركت المدرسة. هنا، ارتفع صوت بكاء الأم بعد أن سمعت حديث ابنها المؤثر.
نظرت إلى ساعتي واكتشفت أن الوقت قد حان لرحيلي.. وأنا أهم بوداعه فاجأني بطلب نفذته بدون أن أعي خطورة ما يترتب عليه؛.. لقد طلب مني أن يقبلني وكان ذلك.
بعدها ودعته وهو يقول لي: قولي لأمي أن لا تبكي الآن وتحتفظ ببكائها لما بعد موتي حتى تتذكرني هي وتتذكريني أنت أيضاً.
وبهدوء خرجت من الغرفة وأنا أحاول التغلب على دموعي تنفيذاً لوصيته.
والآن، وبعد رحيله، كلما تذكرت صورته وصوته اترك دموعي تسقط تباعاً معلنة رفضها لهذه المآسي التي ما زالت تحدث في أكثر من مكان.