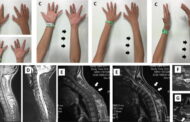في مقال له تحت عنوان (لماذا نقرأ؟ الصورة التي تضيع والكلمة التي تبقى) يتساءل الدكتور بسام بركة حول مستقبل القراءة في ظل هذا العصر الإلكتروني الذي طغت فيه الصورة على الكلمة المكتوبة أو المرئية.
وهو إذ يؤكد حقيقة أن القراءة لن تموت، فهذا مما لا يثير مجالا للشك ولا يورث مدعاة للريب، إذ لا يمكن أن نتصوّر مجتمعا قائما حضاريا دون قراءة، ولا يحق لأمة ترنو ببصرها وتتلهّف بقلبها وتشرئب بعلو همّتها أن تدرك سلم التقدم ومعالي الحضارة أن تستغني عن فعل القراءة، فالقراءة هي جوهر الحضارة ومفتاحها الأصيل وحصنها الحصين الذي يجمع جواهر الفكر وخزائن المعرفة، وهي الثروة الحقيقية للمجتمع بها تعرف الحقائق وتدرك المسالك، ووجودها في المجتمعات كالمنارات العالية التي تلقي بأشعتها من أعلى الجو إلى مدى بعيد من الآفاق وغيابها عنها إنما يعني فقرها الثقافي وحرمانها المعلوماتي ومحدوديتها الحضارية. والقراءة نور، ومن طبيعة النور تبديد الظلام كالنجوم في مناطقها من الفلك ترسل النور ساطعا لامعا في الليالي الحالكات والقراءة تسقي الظمآن في الأوقات الكالحات وأي شيء أجدى من ثقافة العقل؟ لا جدال في ذلك، فالقراءة تجلو الأبصار وتمتع بحسنها الألحاظ وتشحذ الذهن وتقوي القريحة وتستثير دفائن القلوب إنها من بين الحقائق العظيمة في هذا العالم.
وهي الطريق الذي سار على دربه أسلافنا الأولون الذين كانوا يجدون في طلب العلم والمعرفة والوصول إليها ولو كانت تحت التراب، وقد كانوا ينظرون إلى الكتب باعتبارها منافع تزخر بها مكتباتهم ومفاخر تعتز بها أمتهم وتسمو بها عقول أبنائهم وضرورتها للمجتمع كضرورتهم للرغيف أو أشد. وهي المنطلق الذي قامت على أساسه الحضارة العربية الإسلامية الوفيرة التي بدأت بالأمر الإلهي (اقرأ).
في البداية كان القلم
ففي قوله تعالى: (ن والقلم وما يسطرون) تنبيه لخلقه على ما أنعم عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم، وقد أقسم تعالى بالقلم تعظيما لأمره وتنويها بشأنه ولما فيه من الفوائد والمنافع التي لا يحيط بها الوصف وبأنه ينتفع به كما ينتفع بالمنطق، ولهذا قيل إن القلم أحد اللسانين، وهو أول ما خلقه الله. روى ابن أبي حاتم عن الوليد عن عبادة بن الصامت، قال: دعاني أبي حين حضره الموت فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال يا رب وما أكتب؟ قال اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد. وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول شيء خلقه الله القلم فأمره فكتب كل شيء.
وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي قوله تعالى: (اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم). (الآيات: 1، 2، 3، 4، 5) من سورة العلق.
وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم وفيها التنبيه على ابتداء خلق الله من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم فشرفه وكرّمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة، والعلم تارة يكون في الأذهان وتارة يكون باللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، وقد أشرقت بها الدنيا وانبلج بها فلقها، وحرّكت في الإنسان نور المعرفة ونور القرائح ليرتفع بها على ذاته وأنانيته، ويشمل بها مجتمعه وإنسانيته.
لماذا لا نقرأ؟
وإذ ظهر المقال قائما من حيث المعنى والمبنى، واكتسب في المكان والزمان مظهر الحقيقة وجوهرها، إلا أن الحقيقة الغائبة منه والسؤال الأساس هو: لماذا لا نقرأ؟ فالأمور تظهر بنقائضها وهي تعرف من نقائصها والضد بالضد يتضح. وإذا كان المضمون قد اقتصر على أهداف القراءة وفهم ماهيتها، فإن المرء لا يمكنه أن يدرك حقيقة القراءة إلا أن يوجد في الوقت نفسه تشخيص لواقع القراءة وحقائقها. ومن ثم فإن جوهر المسألة يبدأ لدينا من التساؤل: لماذا لا نقرأ؟ لماذا اتسعت المسافة بين الفرد والكتاب؟ ولماذا هذا التباعد العميق القائم بينهما؟
ولعل ما حدث مع القراءة في كثير من بلداننا العربية – إن لم نقل في كلها – من انقطاع بائن وعوز شديد ما يجعلنا نؤكد أننا نعاني أزمة قراءة.
ولا أدل على ذلك من أن أمتنا الجريحة اليوم تعاني هذا النقص المدقع والداء العضال في العزوف عن القراءة بسبب كساد الكتاب وغشاوة القلوب التي بسطت خيوطها وخيوشها عليه.
والحضارة التي كانت تفخر بها يوم استجابتها لكلمة الوحي (اقرأ) لم يعد لها اليوم أثر يذكر بعدما انغمس أبناؤها في حمأة الجهل وتركهم معالي القراءة وسلم العلم.
ورغم السيل الجارف للمجلات والتزايد المستمر للكتب، والغث من الجرائد اليومية والصحف الأسبوعية، فإنه لايزال هناك تراجع في عدد القرّاء، وهبوط في مستوى القراءة وطبيعتها، وضمور يسير في نسبتها.
والآلاف من المطبوعات التي تصدرها دور النشر هو عدد ضئيل بالنسبة لعدد الأفراد الذين أصبحوا غير أميين.
وهناك مشكلة الأمية المعروفة، وهي الجهل الذي يسبق المعرفة، إنها أمية القراءة والكتابة، أمية الدفاتر والأقلام، ونسبتها غير يسيرة في المجتمع العربي.
وهناك مشكلة الأمية المعرفية، وهي أمية المعرفة والمعلوماتية، أمية الكمبيوتر والإنترنت.
وهناك مشكلة الأمية المتعارف عليها، وهي أمية المتعلمين بعد مغادرتهم مقاعد الدراسة.
ولقد أطلعنا الكاتب أحمد أمين – رحمه الله – على هذا الأمر المزمع والحادث المتوقع حين قال: (إن الأمية الراجعة التي تصيب المتعلم الذي لا يواكب ولا يستمر في المطالعة والقراءة بعد تخرّجه أشد من الأمية المعروفة).
ولعل مشكلة التراجع القرائي في المجتمع لا تنحصر في عدد الأفراد الضئيل الذي يقبل على القراءة، بل هناك صيغ أخرى لمثل هذا العوز، من ذلك مشكلة القلة القليلة من الناس التي تقبل على الكتب لتوضع في مكتبة البيت للزخرفة والزينة والرغبة في الاقتناء على أن تكون على تلك الصورة التي يجسّدها لنا أصحاب الموائد والمهتمون بأدب المعدة.
وهي تطل على المكتبة إطلال الواقف على الأطلال والباكي على الآثار، قد هجر صفحات الكتب فلا يرنو إليها، ومعاني الكلمات لا يتعرض لها، ويدخل في تيه المصطلحات فلا يتحرر منها.
وهذه الفئة لا تقارب الكتب إلا من بعيد، ولا تنظر إلى كتبها إلا كما ينظر الجوهري إلى الثروات المخزونة من الذهب والفضة والدرر النادرة والتحف الثمينة، وقد تغيب عنها جانب التفاعل والتواصل.
وها هنا يكمن الفرق بين من يراقب الكتب من بعيد، وبين مكتبة منسجمة متفاعلة مع أهل البيت جميعا قد عرفت الكتب فلم تعرفها مقابر تدفن فيها العقول ولا أفكارا مأسورة في الأذهان، بل عرفتها كما هي الحقيقة قد انطوت على حقائقها وطبيعتها الصادقة، سكبت المعاني في مبانيها وأحاطت القارئ بكل نواحيها ونقّبت عن أفكارها المخبوءة وفتحت له الطريق إلى كنوز المعرفة المدفونة.
وإن كانت هناك بارقة أمل في هذه السماء الثقافية الداجية المدلهمة من القرّاء الذين يقبلون على الكتاب ويولعون بالقراءة، إلا أنهم يوصفون عادة (بالقرّاء الكسالى) فهم يقرأون بشكل واسع، ولكن ليس بشكل جيد وفعال، يقرأون دون ذلك القدر الكافي من الانتباه والاستقراء، ولا بذلك القسط الوافر من التركيز والاستغراق من التفكير المطلوب للفهم الصحيح والكامل. إنهم كما يدعوهم ألكسندر بوب (الحمقى جاهلو القراءة) أو (ضاحلو الثقافة) كما يسمّيهم اليونانيون. ويشير رونالد بار إلى هذا النوع من القرّاء بقوله (قد يتناولون مقلبين صفحات المزيد من الكتب، لكن ما يفعلونه يبدو في كل سنة أقل شبها بالقراءة) إنهم أموات في عالم الأحياء لا أحياء في عالم التراب.
الجامد والراكد
والقارئ الجيد لا يمكن أن تطيب له هذه الحياة الجامدة والطبيعة الراكدة دون وعي بالقراءة والقراءة بشكل فعال.
والقراءة الفعّالة عنده غير القراءة الجامدة، فأما الأولى فتأخذ عناصرها الحيوية وقواها الأساسية فتعمل بها، وأما الثانية فتحبسه عن ناموس العمل وتخضعه ليأكل ويأخذ وتمنعه ليعطي من مادته ولغايته.
وهناك ذرائع شتى يتشبث بها بعض الناس، وأوهام عدة يخلقونها لتبرير عزوفهم القرائي، فمنهم من يتذرع بمشكلة ضيق الوقت وكثرة الواجبات التي امتصت أوقاتهم ولم تترك لهم فرصة للقراءة في حين أن الوقت يذهب عندنا سدى ويضيع فيما لا يجدي هباء منثورا – وقد علمتنا الحياة أن أكثر الناس لا يحفلون بالمطالعة ولا يعيرون للوقت أي اهتمام – ولا أرى لذلك مسوغا من تعلة ضيق الوقت، فالقارئ العادي يستطيع أن يقرأ يوميا بسرعة 300 كلمة في الدقيقة الواحدة، أي يكون بمقدوره أن يقرأ 4500 كلمة في ربع ساعة، ولو عوّد نفسه أن يقرأ كل ليلة وبانتظام ربع ساعة، لأمكن له أن يقرأ 31500 كلمة أسبوعيا و126000 كلمة في كل شهر ليصل المجموع الإجمالي للكلمات خلال السنة إلى 1،512،000 كلمة، وهو ما يربو على عشرين كتابا يقرأه كل عام وبأحجام مختلفة.
ومنهم من يتعلل بالعوز المالي والقدرة الشرائية، أفلا يستطيع أحدنا أن يوفر مبلغا من المال – قل أو كثر – لشراء مجلة أو اقتناء كتاب؟ أم أن المستوى الاقتصادي والعقلي والاجتماعي يسمح فقط بشراء سيارة وتلفزيون وأجهزة كهرومنزلية؟ وإذا كان أمرنا كذلك، فإن العالم العربي قديما كان شديد الولع باقتناء الكتب وكانت رغبته الملحة في امتلاك مكتبة خاصة.
لذلك فالكتاب أغلى من أن يقاس بثمن والقراءة أثمن من أن تضيع، وإنما يعرف مقدار الشيء من قيمته وليس من ثمنه، وليعلم المرء أن موضع كل صفحة من صفحات كتبه هو ثروته، وحاجته العقلية هي الحاجة الحيّة والدافع الأساسي والفاعل الحقيقي. فلا ينظر إلى الكتب بطريقة أصحاب الحوانيت الصغيرة.
ويذهب آخرون إلى أن القراءة لم تعد ضرورية اليوم ولا مطلوبة كما كانت الحال فيما مضى – يتلقف فيه الفرد الكتاب بنهم مفعما بحبّه موفّرا له من جهده ووقته وذاته – وذلك لأن الصور التلفزيونية قد أغنت عن فعل القراءة، وهذا توهّم خاطئ ومذهب منكر، وإذ نبين أن التلفزيون يؤدي خدمات متعددة، ويلبي حاجات مختلفة، إلا أن القراءة تبقى سيدة الموقف. وتظل تتمتع بنفوذها، ولاتزال تؤدي وظائف تعجز الصـــور التلفزيــونــية عـــن تأديتها ولا تستطيع تحقيقها، فمثلا (التلفزيون يجعلك تلقي نظرة عابرة على الصفحة وذلك شيء يختلف كثيرا عن القراءة) كما يقول رونالد بار. وكما يلاحظ بروتو بتلهايم (فإن التلفــزيون يأمـــر الخــيال لكنه لا يحرره، أما الكتاب الجيد فإنه ينبّه الذهن ويحرّره في الوقت ذاته).
وخلاصة القول فإن مسألة العزوف عن القراءة خطيرة جدا، والأمر خطب، ولكن الأخطر ما يترتب عنها من نتائج، وهذا مما لا يخفى ضرره على بصير ولا يرى أثره إلا حصيف.
لذلك فحسّ الأمة وشعورها ووعيها الشخصي يعد من أول الاهتمامات، وأن يشغل ذلك فكر أبنائها إلى أن يعرفوا الأشياء على حقائقها والتغلغل إلى دقائقها. ومن ثم أولا يلزم حملها على تقصّي الأسباب جميعها ومجتمعة من أجل التخفيف من وطأة هذا الداء.
وقد آن الأوان، أكثر من أي وقت مضى، أن نفك الخيوط، وأن نبدد فكرة اللاقراءة واللاكتاب، وأن ننتقل إلى عالم القراءة وحضارة الكتاب، وأن نحوّل مجتمعنا العربي إلى مجتمع قارئ، وأن تتحول قراءتنا الفعلية والفعّالة إلى حقيقة لا إلى أنصاف حقيقة ولا أشباه حقيقة ولا تزييف لحقيقة، لينضاف إلى معناها سر المعنى وسر الحياة، وتترك كلمة الوحي (اقرأ) على حقيقتها تتكلم بحريتها، وليذكرها التاريخ بشواهد وبصمات تمثل تمثال نهضتها وتحفظ ماء الوجه لحضارتها.
وإن أحسن وجهة نأخذها في هذا التحول وهذا الانتقال هي توفير المناخ الثقافي المناسب وذلك بأن تدخر الأمة قوة العلم وسلاح المعرفة لوقتها وللوقت الذي لم يحن بعد، وأن توفر لأبنائها حاجتهم من الكتب، وتوجيه النظر إليها وكيفية التعامل معها، وأن تشجعهم على الإبداع والحوار البنّاء والنقد الفعّال والإقبال الواعي على القراءة الواعية، وأن تؤهلهم للدخول إلى عالم الكتب والقراءة والمكتبات، وأن تفسح في المجال للأدب والأدباء، وأن تقدس العلم وتبجل العلماء، وأن تعلي شأن الكتاب والكتّاب، وترفع قيمة الفكر والأفكار.
دور كبير
والمجتمع القارئ لا يتم تمامه ولا تقوم قاعدته إلا بتكوين طفل قارئ – وكان طبيعيا أن يكون الطفل بؤرة الاهتمام ومحور الانتباه – بعدما ثبت أن الركائز الأساسية للشخصية تبنى في السنوات الأولى من حياته. فالأهل في هذه السنوات يلعبون دوراً كبيراً في تشجيع الطفل على القراءة وهم يشكّلون دور الوسيط بين الطفل والكتاب وهم القادرون على جعله يولع بحب الكتاب ويبحث عنه ويطالب بالحصول عليه، وذلك من خلال توجيه نظره إلى الكتاب ونظرته إليه ورؤية الأم تمسك الكتاب وتقرأ له، والأهل يقرؤون هي إحدى الوسائل التي تجعله يتقبل فكرة التعلم وحب الاستكشاف وشغف المطالعة، فيعتاد ذلك منذ الصغر ويرغب أكثر في القراءة. وكما يقول أحد الكتاب التربويين (إن قرّاء المستقبل هم نتاج الأمهات والآباء الذين يقرأون لأطفالهم منذ الطفولة ويقرأون لهم خلال لحظات الهدوء اليومي ويقرأون لهم عند النوم ليلا فعندئذ يغدو الكتاب عنصرا أساسيا من عناصر الحياة).
وأخيرا متى صدق المرء في حبّه للقراءة وما فيها من طعام العقول ونور القرائح، ونعمة الحكمة، وسلطان البيان، كانت فكرته فكرة مضافة للوجه الآخر، ويماثله في الشعور ويرافقه في الإحساس. وبذلك تدخل الفكرة بهذا التلاقي والتواصل والتفاعل والانسجام والتكامل إلى عالم الأفكار لتزيده قوة ومنعة ومتعة وعمقا.
ومتى بلغت أمة أشدها واستوى عودها وعرفت للقراءة قدرها نالت عزّها واسترجعت حضارتها.
ومتى عرفت عزوفا عن القراءة وندرة في عدد القرّاء واستوى في هذه الندرة صغيرها وكبيرها، كانت كمن خط الشيب رأسها ولوّحت الشمس بشرتها، قد أنهكت الأمراض والوساوس أعصابها ونالت من الهلكة مآلها.
وهل يرتجى من أمة لا تقرأ أن تنهض بأبنائها وأن تكسبهم منعة من داء عوز القراءة؟
بل إن الأمة التي لا تقرأ تكون قد حكمت على أفرادها بالتقهقر والتلاشي. بل إن الأمة التي لا تقرأ هي في ذاتها تحمل بذور النهاية والفناء.
حي بن حميدي صبرة
تلمسان – الجزائر