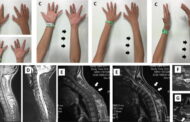جورجينا بهنام
تساؤلات كثيرة تطرحها علينا رواية (يا مريم) للروائي العراقي سنان أنطون* وأخرى ربما أكثر منها يطرحها القارئ وهو ينتقل بسرعة ودون أن يشعر بين فصول الرواية حتى يصل إلى غلافها الأخير وهو يتساءل متى انتهيت من القراءة؟ أبهذه السرعة شاهدت ذلك الشريط الذي مر أمامي عارضاً حياة هذه المجموعة المختارة من الشخصيات الواقعية التي تكاد تشعر وأنت تقرأ عنها أنك تعرف واحدا منهم في الأقل؟
هل تعيش في الماضي؟
أن تعيش في الماضي هل يشكل ذلك اتهاماً أو عيباً أو حتى سبة أو جريمة بل ربما لعنة تلاحق المتورط فيها؟ سؤال يطرح نفسه مع الصفحات الأوَل من الرواية عندما احتدم النقاش واشتعلت الأجواء بين الشخصيتين الأبرز في الرواية (مها) و(يوسف) وهو أمر طبيعي سيما وأن يوسف قد جاوز عقده الثامن بينما ما تزال مها في بداية العشرينات، الأول متقاعد ومنقطع عن العالم الخارجي والثانية طالبة جامعية تضطر للخروج من البيت يومياً وملاقاة أصناف وأنواع جديدة من البشر لم يتعرف إليهم يوسف في زمنه، هي تسمع وترى وتعيش أحداثاً يغلفها الظلم والتمييز بينما هو ما يزال ينظر إلى العالم بمنظار المحبة والأخوة والتسامح وكلها قيم ترى مها أن وجودها بات قليلاً بل ربما معدوماً في أيامنا هذه، هو يصر على أنها سحابة صيف ستمضي فيما تؤكد هي له أن ما حدث بعد 2003 وما يزال يحدث طوال هذه المدة من قتل وتهجير وتفجير وموت بلا ثمن لا يمكن أن يكون عابراً.
وخرجت المحادثة عن سياقاتها المعتادة وعلا صوتها متهمة العم يوسف أنه يعيش في الماضي، ولكن ما العيب في ذلك؟ ولماذا لجأ زوجها (لؤي) إلى الاعتذار مؤكداً للعم يوسف أنها ستعتذر أيضاً، لماذا؟ هل من العار أن تعيش في الماضي؟ ما دمت غير قادر على التكيف مع الحاضر الذي بات مؤلماً بل مخزياً كأنه طفل غير شرعي لتلك الأيام الجميلة التي كان فيها جميع العراقيين يشعرون بأنهم إخوة يجمعهم حب الوطن. فيعود يوسف ليطرح هو بدوره أسئلة عدة: (هل أهرب فعلاً من الحاضر إلى ملجأ الماضي كما اتهمتني هي؟ وما العيب في ذلك؟ حتى لو كان صحيحاً، إذا كان الحاضر مفخخاً ومليئاً بالانفجارات والقتل والبشاعة (..) ثم هل مات الماضي أساساً كي لا أعيش فيه؟ (..) يجب أن أسامحها فزمانها غير زماني، وشبابها غير شبابي، هي فتحت عينيها الخضراوين على الحروب والحصار وذاقت طعم القحط والقتل والتشرد مبكراً، أما أنا فعشت أزمنة الخير وما زلت أتذكرها وأصدق أنها حقيقية).
«المتاحف تشهد» هل باتت هي المكان الوحيد الذي يسمح فيه بوجود الآخر المختلف؟
في ظل احتدام النقاش وفي خضم سورة غضب البطلة (مها) تطرق الحديث إلى وقائع كثيرة، حيث قال يوسف: (البلد بلد الكل، بلدنا وبلد أجدادنا، إحنا قبل غيرنا، التاريخ يثبت من زمن الدقناووس من الكلدانيين إلى العباسيين فالعثمانيين وتاريخ الدولة العراقية المتاحف تشهد، إحنا موجودين قبل غيرنا، إذا مو بلدنا لعد بلد منو ما تقليلي؟ (…) قالت مها بألم وبعد آهة: هو آخرتنا راح نصير بالمتاحف احنا همينا، يمكن كان بلدنا قبل، عمو، أيام زمان.. كان.. بالماضي.. هسه خلص.. كلنا كفار وذميين).
تساؤل جديد تطرحه الرواية يبحث عن إجابة بين الأحداث الدامية التي يشهدها العراق، هل سيختفي كل أثر للآخر المختلف الذي يسمى أقلية / أقليات؟ هل ستغدو المتاحف التي لم تسلم هي الأخرى من الدمار والسرقة والتخريب، هي المكان الأمثل لأبناء الأقليات الأصيلة الذين تعود جذور وجودهم في العراق إلى السومريين البابليين والآشوريين بعد أن يخلو البلد من أبنائها الأحياء؟ لعل هذا التصور هو الذي جعل مخيلة يوسف تشطح في حلم غريب رأى فيه نفسه سادن متحف ودليلاً للزائرين يشرح لهم عن كل غرفة من غرف المتحف الذي لم يكن سوى بيته الذي خلا من سكانه وراح هو يشرح من كان يسكن هنا والى أين هاجر. لكن صدمة الحلم لم تتوقف هنا بل زاد من تعقيد اللحظة ظهور دليل آخر راح يضلل الزائرين مقدماً معلومات مغلوطة فيما يوسف يحاول جاهداً حتى في حلمه أن يحافظ على الهوية الأصلية للبيت وساكنيه كونه صاحبه والدليل الأحق، لكن أحداً لم يره ولم يعبأ به، مما قد يحيلنا إلى تساؤل أكبر وأعمق هل ستفقد الأقليات مكانها حتى في المتاحف؟
متى ينتهي الرحيل؟
في فصل (صور) الكثير من المعلومات المختزلة عن عائلة البطل يوسف، لعل أبرزها أخبار ذلك الرحيل الدائم لأفراد هذه العائلة والتنقل بين الأماكن الذي لا يكاد ينتهي إلا مع الرحيل إلى الدار الآخرة. فالوالد (كوركيس) يبدو في الصورة الملتقطة قبل شهور من حركة رشيد عالي الكيلاني عام 1941، (جالساً بوقار في قلب الصورة يرتدي الصاية واليشماغ ملفوف حول رأسه على طريقة القادمين حديثاً من قرى الشمال، رغم أنه كان قد هجر تلكيف وجاء إلى بغداد قبل أكثر من ثلاثة عقود، إلا أنه رفض أن يغير ملابسه ويلبس (أفندي) مهما ألح عليه الآخرون وظل يرتدي هذا الزي حتى موته عام 1957). وهو الذي عاش متنقلاً بين بغداد والمحمرة سعياً وراء الرزق، تلك الصورة كانت الوحيدة التي تجمع أبناء كوركيس قبل أن تفرقهم الأيام.
غازي: عمل في كركوك ثم إلى بغداد ثانية فالهجرة إلى أمريكا بإلحاح من زوجته التي سبق إخوتها فهاجروا إلى هناك. جميل: سيرحل إلى لبنان موطن زوجته هرباً من الإعدام الذي طال صديقه بتهمة الماسونية. إلياس: يتورط في السياسة ويصبح شيوعياً وعبرها (السياسة) يتعرف إلى زوجته ويدخل السجن أكثر من مرة حتى يبدأ الرحيل المعنوي أولاً بذهاب ذاكرته وإصابته بالزهايمر، ثم وصل رحيله منتهاه بوفاته تائهاً في حي لا يعرفه فيه أحد، ليفجر أحد رفاقه القدامى مفاجأة المضحك المبكي، فهو لم يته تماماً بل كانت تلك الدار حيث وجدوه مكان اجتماع خليتهم أيام العمل السري! ميخائيل: الأخ الاصغر يعزل نفسه عن العالم بعد ضياع حلمه بالثراء فيرحل روحياً متوحداً وما عاد يشارك في المناسبات العائلية وزيارات الأقارب بل ظل هارباً من الواقع يحتسي ما شاء من الخمر حتى أوصلته إلى آخرته.
لم تجتمع العائلة في صورة أخرى إلا في تلك الملونة الوحيدة التي يعود تأريخها إلى عام 1990 (كان كل أولاد كوركيس حنا بهارتلي وأولادهم وأحفادهم في هذه الصورة، ولم تجمعهم صورة بعدها أبداً، فبعد غزو الكويت الذي وقع بعد أقل من شهر من تلك الحفلة، جاءت حرب أخرى واصطحبت معها الحصار الطويل. وبدأ الأخوة والأخوات يتساقطون من شجرة العائلة لتجرفهم الريح إلى الغربة او لتبتلعهم الأرض في قبر العائلة).
عائلة مها بدورها عانت الرحيل بعد استهداف بيتهم في الدورة، فرحلوا إلى عنكاوا ثم عادت مها مع زوجها إلى بيت العائلة عندما ظنوا أن المنطقة باتت آمنة لكن التفجير الذي وقع على عتبة دارهم أجبرهم على الرحيل مجدداً وقبلهم رحل جنين (مها) تاركاً أماً ثكلى ناقمة تبحث عن ملاذ آمن في ديار الغربة وتعيش يومها على أمل أن يوم الرحيل بات أقرب.
ومن مستعجلي الرحيل أيضا (نسيم حزقييل) صديق يوسف اليهودي الذي جمعته إحدى الصور المعلقة بيوسف وصديقهم الثالث (سالم حسين) حينما لخص نسيم الأمر بعبارة واحدة: (يمكن هاي آخر مرة نتشاوف) فأردف صديقه سالم: (يالله، بلكن تروحون جم شهر ومن تنحل مشكلة فلسطين ترجعون).
وظلت هذه الـ (بلكن) بلا إجابة بعد تواصل الرحيل الذي لم يستثن أي طيف من أطياف الشعب العراقي فما عاد اليهود والمسيحيون ولا حتى الصابئة والايزيديون هم رواد قافلة الرحيل فالكل باتوا مستهدفين ـ كما كان يوسف يؤكد ـ وبالتالي الكل يريدون الرحيل فلمن ستتركون العراق؟
لماذا تأخرت؟ هل حقاً أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي؟
تأخر إعتذار مها ليوسف طوال النهار، فهي لم تصادفه قبل أن يخرج للقاء صديقه بعدما نزلت متأخرة ثم تأخرت في العودة إلى البيت بسبب الزحام الذي سببه استنفار أمني وكذا زوجها (لؤي) اتصل ليخبرها أنه سيتأخر، في الكنيسة الذين تأخروا عن الخروج إلى الغرفة المجاورة هرباً كما فعل يوسف، كان أغلب الضحايا من بينهم. وشمل التأخير أيضاً وصول القوات العراقية المنقذة فتساءلت مها باللهجة المحكية: (السؤال هو ليش انتظروا كل هذا الوقت؟ لو تحركوا أسرع كان أنقذوا كثير ناس من اللي كانوا ينزفون واللي ما كان لازم يموتون، وكان عدد الضحايا أقل بكثير). تأخر إخلاء جثة يوسف أربع ساعات حيث بقي جثمانه مسجى على أرض الكنيسة قبل أن يحمل إلى الخارج، لم يشعر بالألم لأن أحد الجنود كسر أصابعه (فواحدة من الرصاصات الأربع التي كانت قد اخترقت جسده قبل ساعات كانت قد عثرت على قلبه وأسكتته. وقبل أن يسكت قلبه، كانت شفتاه قد همستا بصوت خافت: يا مريم).
- رواية (يا مريم) لسنان أنطون رواية عراقية صدرت عام 2012 عن دار الجمل ورشحت ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية لعام 2013.
- حاول الكاتب إضفاء أجواء من الواقعية عبر الحوارات التي استخدمت اللغة الدارجة القريبة من اللهجة الموصلية.
- ابتعدت الرواية عن الإطالة إذ اكتفت بـ (156) صحيفة لئلا يتسرب الملل إلى نفس القارئ المعاصر الذي لم يعد يمتلك ذات النفس الطويل لقراء الأزمنة الذهبية.
- الابتعاد عن المباشرة في طرح موضوع (مجزرة كنيسة سيدة النجاة) أمر يحسب للكاتب.
سنان أنطون:
- شاعر وروائي ومترجم ولد في بغداد عام 1967. له روايتان: (إعجام) و(وحدها شجرة الرمان)، فضلاً عن رواية (يا مريم) وديوان شعر بعنوان (ليل واحد في كل المدن) والعديد من المقالات بالعربية والانكليزية.