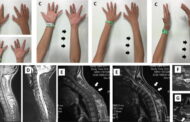قصة بالروسية لإيفان بونين
رحلت الفتاة التي كنت أحبها، دون أن أقول لها شيئاً عن حبي، ولأنني كنت آنذاك في الثانية والعشرين من عمري، فقد خيل إليَّ أنني أصبحت وحيداً في الدنيا بأسرها. كان ذلك في نهاية شهر أغسطس، حيث كنت أعيش في مدينة روسية صغيرة. كان هناك هدوء قائظ. وفي يوم السبت عندما غادرت بعد الدوام ورشة صنع البراميل حيث كنت أعمل. بدت الشوارع مقفرة إلى حد أني عدلت عن الذهاب إلى منزلي، واتجهت صوب الضواحي لا ألوي على شيء.. سرت على الأرصفة بمحاذاة متاجر يهودية مغلقة وأروقة التسوق القديمة.
دقت أجراس الكاتدرائية في حين سقطت من الدور ظلال طويلة دون ان تخف وطأة الحر. وهذا ما يحدث عادة في المدن الجنوبية في أواخر اغسطس، حين تلفح أشعة الشمس الحدائق الغبراء طوال الصيف. كنت حزيناً حزناً لا يصدق، في حين كان كل ما حولي قد جمد من ملء السعادة – في الحدائق والسهوب والبساتين، وحتى في الهواء ذاته وفي أشعة الشمس الكثيفة.
في الساحة المتربة، قرب حنفية الماء كانت تقف امرأة أوكرانية جميلة وجسيمة، ترتدي قميصاً أبيض مطرزاً، وتنورة من قماش محلي سوداء ضيقة، تبرز وركيها وترتدي حذاءً بأربطة على قدميها العاريتين. امرأة تشبه فينوس، من بعض الوجوه، إذا كان بمقدورنا أن نتخيل فينوس سمراء مدبوغة بأشعة الشمس. عيناها عسليتان بهيجتان، جبهتها صافية ناصعة نصاعة لا تتسم بها سوى النساء الأوكرانيات والبولونيات.
ملأت الدلو بالماء وعلقته على كتفها من حامله الخشبي المقوس، وأقبلت نحوي مباشرة ـ رشيقة على الرغم من ثقل الماء الذي كان يتساقط وهي تتثنى في مشيتها قليلاً وتدق الرصيف الخشبي بكعب حذائها. أذكر أنني انتحيت جانباً في إجلال لأفسح لها الطريق، ونظرت في أثرها طويلاً.
وفي الشارع الممتد من الساحة إلى طرف منحدر الجبل كان ثمة وادي شاسع هادئ الزرقة لنهر ومروج وغابات، ووراءها رمال سمراء ذهبية تمتد حتى الأفق الجنوبي الرهيف.
ويبدو أنني لم أحب روسيا الصغرى قط، كما أحببتها في ذلك الحين، ولم أعشق الحياة، كما في ذلك الخريف، الذي لم أكن اتحدث فيه إلا عن صراع الحياة. ولا أعمل شيئاً سوى التدريب على حرفة صنع البراميل.
والآن وأنا أقف في الساحة قررت زيارة مريدي تولستوي الذين يعيشون في الضاحية، انحدرت نحو أسفل الجبل وصادفت في طريقي العديد من سائقي العربات الذين كانوا منهمكين جداً في نقل الركاب القادمين في قطار الساعة الخامسة الواصل من شبه جزيرة القرم.
الخيول الضخمة تتسلق الجبل ببطء وتجر عربات مثقلة بالصناديق والبالات والبضائع الفواحة والسائقين والغبار والناس القادمين من مكان ما لا بد أنه بهيج. كل هذا أخذ يعتصر قلبي مرة أخرى، فينقبض من أمنيات حزينة وحلوة.
التفتُ إلى ممر ضيق بين الحدائق، ومشيت لفترة طويلة نحو إحدى الضواحي، التي يقطنها العمال والحرفيون والكسبة، الذين كانوا في العادة يخرجون إلى الوادي في ليالي الصيف، ويغنون بصوت عال ووحشي ورائع كجوقات الكنيسة، أغاني قوقازية جميلة وحزينة. أما الآن فهم يطحنون.
وهناك في الأطراف حيث الأكواخ الخشبية الزرقاء والبيضاء بين الحدائق في بداية الوادي، كانت سلاسل الطواحين تلمع، ولكن في أعماق الوادي كان الجو قائظاً كما في المدينة. وسارعت إلى تسلق التل، نحو السهل المفتوح، الذي كان ساكناً وواسعاً. كان السهل كله على مدى البصر وأكوام القصب السميكة العالية تبدو ذهبية. وكان الغبار الكثيف يغطي الطريق اللانهائي العريض، ويخيل للمرء كأنه يرتدي حذاءين مخمليين، وكان كل شيء من حولي يشع ببريق خاطف من أثر قرص الشمس المسائي الواطئ – الطريق والهواء والحصيد، مرّ كهل أوكراني أسود من لفحة الشمس، بحذاءين ثقيلين، ويرتدي قبعة جلدية، ويحمل لفة بلون حبوب الجاودار. وكان العكاز الذي كان يتكئ عليه يلمع كما لو كان زجاجياً. وكانت أجنحة الغربان المحلقة فوق الحصيد لامعة ومشرقة أيضاً، ولابد من اتقاء هذا الحر والبريق بحواف القبعة الساخنة. وبعيداً عند الأفق تقريباً، كان يمكن تمييز عربة يجرها زوج من الثيران بتثاقل وبطأ، وكوخ حارس حقل بطيخ… آه لروعة هذا الصمت والرحابة، ولكن روحي كانت تهفو نحو الجنوب، وراء الوادي، إلى حيث رحلت هي على مبعدة نصف ميل من الطريق كان ثمة منزل ريفي، ذو سقف من القرميد الأحمر. هو عزبة الأخوين (بافل وفيكتور تيمجينكوف)، مريدا تولستوي. توجهت إلى هذا المنزل فألفيته خالياً. تطلعت من النافذة، فلم أر أحداً، بل سمعت طنين الذباب، أسراب من الذباب على الزجاج وتحت السقف، وعلى أواني الزهور الموضوعة على بسطة النافذة.
كانت ثمة زريبة للحيوانات ملحقة بالمنزل، ولكني لم أجد فيها أحداً. كانت بوابتها مفتوحة، والشمس تلفح الفناء الغارق في السماد. وعلى حين غرة سمعت صوتاً أنثوياً يسأل:
ـ إلى أين أنت ذاهب؟
التفتُ، فرأيت زوجة تيمجينكوف الأكبر أولغا سيميونوفنا، جالسة على الجرف المطل على الوادي على حافة حقل البطيخ. ودون أن تنهض مدت لي يدها، فجلست بجوارها، وقلت وأنا أنظر في وجهها مباشرة:
– هل أنت ضجرة؟
أطرقت رأسها، وجعلت تنظر إلى قدميها العاريتين. امرأة صغيرة مدبوغة بأشعة الشمس، في قميص متسخ وتنورة بالية مصنوعة من قماش أوكراني محلي الصنع.
كانت أشبه ببنت صغيرة أرسلوها لحراسة أشجار الكستناء، وقضت في حزن يوماً مشمساً طويلاً، وكان وجهها أشبه بوجه فتاة مراهقة من قرية روسية. ولكني لم أستطع أبداً أن اعتاد على ملابسها، وعلى حقيقة أنها تخوض في الروث والحصيد الجاف حافية القدمين، حتى أنني خجلت من النظر إلى قدميها. وهي نفسها كانت تضمهما وتختلس النظر إلى اظافرها التالفة. وكانت قدماها صغيرتين وجميلتين.
– ذهب زوجي إلى الطاحونة القريبة، ورحل فيكتور نيكولاي.. أعتقل بافلوفسكي مرة أخرى لرفضه الالتحاق بالجيش.
– هل تتذكر بافلوفسكي؟
قلت على نحو آلي: أتذكر
وصمتنا ونظرنا لفترة طويلة إلى زرقة الوادي وإلى الغابات والرمال، وإلى الأفق الذي يدعونا بكآبة.
وكانت الشمس ما تزال تدفئنا، وتدفأ أيضاً ثمار البطيخ المستديرة الثقيلة الجاثمة بين سيقانها الصفراء الطويلة الملتفة كالثعابين.
أبتدرتها: لم لا تصارحينني وتكبتين مشاعرك؟ أنت تحبيني!!
تكورت، وسحبت ساقيها وأغمضت عينيها، ثم ازاحت خصلات شعرها عن خدها وقالت بنبرة حاسمة وهي تبتسم:
– أعطني سيجارة.
اعطيتها السيجارة، فسحبت نفسين عميقين.
ثم سعلت ورمت السيجارة بعيدا وقالت وهي تفكر:
– أنا جالسة هنا منذ الصباح، يأتي الدجاج لينقر البطيخ هنا، لا أدري لم يخيل إليك أن هذا المكان ممل، أنه يروقني للغاية.
فوق الوادي على مبعدة ميلين من القرية توقفتُ عند الغروب. نزعتُ قبعتي، وأخذتُ من خلال الدموع أتطلعُ إلى الافق… إلى مكان ما بعيد، تراءت لي مدن جنوبية قائظة ومساء أزرق وصورة امرأة ما تتداخل مع صورة الفتاة التي أحبها، بيد أني أضفت إلى الصورة في سري، ذلك الحزن الطفولي الذي كان في عيني تلك المرأة الصغيرة في تنورة من قماش محلي الصنع.
جودت هوشيار، مهندس وباحث وكاتب عراقي معروف، أصدر العديد من الكتب الفكرية والأدبية القيمة، منها (ذخائر التراث الكردي في خزائن بطرسبورغ) وبموازاة نشاطه الهندسي، كتب مئات الدراسات الفكرية في الصحف والمجلات الرصينة في العراق والعالم العربي. متفرغ حالياً للدراسات الفكرية. نتاجاته تنشر في الصحف والمجلات العربية والعراقية والكردية ومنها (الإتحاد) و(التآخي) و(كل العراق) و(صوت الآخر) وغيرها.. يتقن اللغات العربية والكردية والتركية والروسية والإنجليزية.